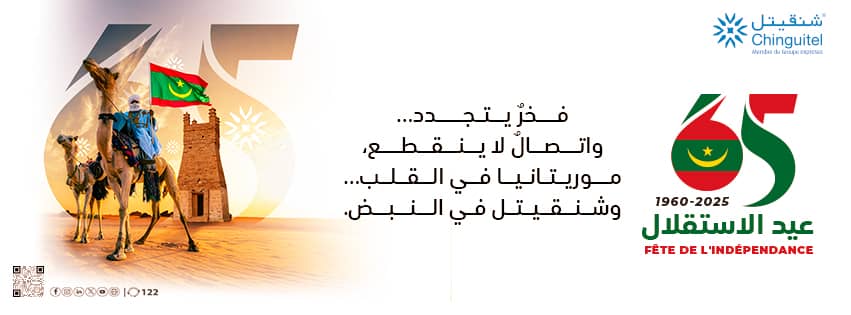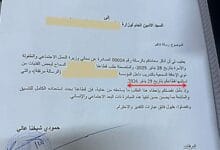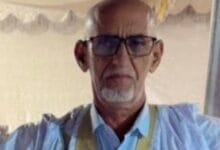موريتانيا: مفترق طرق الهجرة بين الصرخة الإنسانية والمعادلة القانونية

لم تعد الهجرة مجرد انتقال أفراد من بلد إلى آخر بحثا عن حياة أفضل، بل غدت واحدة من أعقد القضايا التي ترسم ملامح العلاقات الدولية والاجتماعية في عالمنا المعاصر. فهي منظومة متشابكة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع الاعتبارات القانونية، وتتقاطع فيها الأحلام الفردية مع الحسابات الاستراتيجية للدول. وإذا كان البحر الأبيض المتوسط قد تحول إلى رمز عالمي لمآسي الهجرة غير النظامية، فإن موريتانيا باتت بدورها مسرحا بالغ الرمزية لهذه الظاهرة، بحكم موقعها الجغرافي الحساس وتاريخها الاجتماعي والاقتصادي
– بوابة الأطلسي وممر العابرين ..
تقع موريتانيا على تماس استراتيجي بين المغرب العربي وعمق إفريقيا جنوب الصحراء، وتطل على ساحل أطلسي يزيد طوله على 700 كيلومتر، لتصبح نقطة ارتكاز على واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. فمن مدينتي نواكشوط ونواذيبو تنطلق قوارب خشبية متهالكة تقل مئات المهاجرين القادمين من غينيا ومالي وساحل العاج ونيجيريا والسنغال، أملا في بلوغ جزر الكناري الإسبانية، أقرب بوابة إلى “الفردوس الأوروبي”.
لكن هذه الرحلات كثيرا ما تتحول إلى مآسٍ مروعة. قوارب تغرق في عرض البحر، وعائلات تفقد أبناءها بلا أثر، وناجون يروون قصصا عن عطش وجوع وموت يفتك برفاقهم قبل أن يلمحوا شواطئ النجاة. وقد دفعت هذه الكوارث الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع موريتانيا منذ عام 2006، تشمل مراقبة الحدود البحرية والبرية وتسيير دوريات مشتركة. وهكذا تحولت نواكشوط إلى “حارس غير معلن” للبوابة الجنوبية لأوروبا، في ترتيبات لا تخلو من جدل حقوقي بشأن مدى توافقها مع التزامات البلاد الإنسانية والدولية.
– مآسي البحر في الأرقام ..
تشكل حوادث الغرق واحدة من أشد الصور مأساوية في مسار الهجرة عبر موريتانيا. ففي سبتمبر 2019 أعلنت السلطات الموريتانية عن غرق قارب يقل ما يزيد على 150 مهاجرا، ولم يُعثر إلا على عشرات الجثث بينما اعتُبر الباقون في عداد المفقودين. كما شهد شهر نوفمبر 2020 واحدة من أبشع الكوارث حين غرق قارب يقل أكثر من 140 شخصا قرب مدينة نواذيبو، ولم ينجُ منهم سوى عشرة. وفي مارس 2023 تم انتشال جثث 24 مهاجرا قبالة بوادي بولاية داخلة نواذيبو، بينما أنقذت خفر السواحل نحو 120 آخرين. وفي يوليو 2024 لقي 61 شخصا حتفهم إثر غرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة ساحل العاصمة نواكشوط. وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أعلنت في ابريل الماضي، أنه تم العثور على أكثر من 100 جثة لمهاجرين منذ بداية العام، واستنكرت ما وصفته ب”المأساة الإنسانية” التي تسببت بها “شبكات إجرامية” للهجرة غير الشرعية، على حد تعبيرها.
هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن حوادث معزولة، بل تعكس نزيفا إنسانيا متواصلا يجعل من المحيط الأطلسي مقبرة صامتة لأحلام الشباب الإفريقي الباحث عن “الخلاص”.
– موريتانيا المهاجرة: من نزيف الداخل إلى آفاق الخارج
غير أن موريتانيا ليست مجرد معبر للآخرين، بل هي أيضا بلد يصدر أبناءه إلى شتى بقاع الأرض. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ومع اجتياح موجات الجفاف والتصحر، وجد آلاف الموريتانيين أنفسهم مدفوعين إلى الهجرة كخيار للبقاء.
إفريقيا.. الجذور الأولى ..
اتجهت أولى الموجات إلى دول الجوار الإفريقي. في السنغال وساحل العاج وغامبيا والغابون والكونغو وأنغولا أسس الموريتانيون محال تجارية وأسواقا صغيرة، حتى بات حضورهم هناك جزءا من المشهد الاقتصادي اليومي. وساعدتهم الروابط الدينية واللغوية والقبلية على الاندماج السلس داخل المجتمعات المحلية، وإن ظلوا متمسكين بهويتهم الثقافية.
أوروبا.. الحلم المرهق ..
مع التسعينيات، تزايدت الهجرة إلى فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. فالقرب الجغرافي، واللغة، والإرث الاستعماري سهلوا الطريق. وفي باريس ومدريد وبرشلونة وبروكسل ولييج تنتشر جالية موريتانية نشطة، تمارس التجارة والعمالة اليدوية والنقل. لكن “الحلم الأوروبي” لم يكن مفروشا بالورود؛ فقد واجه المهاجرون صعوبات اندماج، وقيودا قانونية، وأحيانا تمييزا صريحا.
الخليج.. الدين والتجارة ..
في المقابل، شكلت دول الخليج وجهة مركزية، خصوصا السعودية والإمارات وقطر. هناك برز الموريتانيون في مجالات القضاء والإعلام والتعليم والدعوة الدينية، بينما انخرط آخرون في التجارة الحرة أو الأعمال البسيطة وقطاعات الأمن. وقد وفرت هذه الوجهة دخلا ثابتا لآلاف الأسر في الداخل، وأسهمت في ترسيخ صورة الموريتاني كمغترب يعتمد على ذكائه وصلابته.
أميركا.. الموجة الأحدث ..
أما التطور اللافت في العقدين الأخيرين، فهو الموجة الجديدة نحو الولايات المتحدة الأميركية وكندا. فقد بدأت بخطوات خجولة مطلع الألفية، ثم تسارعت حتى غدت مدن مثل سينسيناتي ونيويورك وكولومبوس وتورينتو ومونتريال مراكز استقرار لجاليات موريتانية شابة تبحث عن فرص اقتصادية وتعليمية أوسع. وتميزت هذه الهجرة بكونها أكثر تنظيما، إذ ظهرت جمعيات أهلية وروابط جهوية تسهل اندماج الوافدين، وتؤمن لهم شبكة دعم اجتماعي، فضلا عن التحويلات المالية المنتظمة التي صارت شريان حياة لأسر عديدة في الداخل.
المناخ والاقتصاد.. محركات الرحيل ..
لا يمكن قراءة الهجرة الموريتانية دون العودة إلى العامل المناخي. فموجات الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد منذ السبعينيات دمرت أنماط العيش التقليدية القائمة على الرعي والزراعة، ودفعت سكان الأرياف إلى النزوح أولا نحو المدن، ثم إلى الخارج. وإلى جانب المناخ، تقف الأزمة الاقتصادية مزمنة: بطالة عالية بين الشباب، وقطاعات إنتاجية ضعيفة، ومحدودية في فرص العمل. كل ذلك جعل الهجرة حلا فرديا لأزمة جماعية.
وتبرز التحويلات المالية للمغتربين كعنصر رئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تفوق قيمتها أحيانا بعض الصادرات الرسمية. فهذه الأموال تُسهم في تمويل التعليم والصحة وبناء المنازل، لكنها في الوقت ذاته تُعمق اعتماد الأسر على الخارج بدل الاستثمار في الداخل، مما يطرح سؤالا عن استدامة هذا النموذج.
– وجوه إنسانية للهجرة
وراء الأرقام قصص تنبض بالمعاناة والأمل. شاب من ضفاف النهر يروي كيف باع ماشيته بعد أن جفت المراعي، لينتقل إلى دكار بائعا متجولا، ثم إلى الدار البيضاء عاملا في مطعم، قبل أن يغامر بالوصول إلى برشلونة حيث يعيش بلا أوراق ثبوتية. وعلى الجهة الأخرى، تحكي شابة من مالي أنها عبرت موريتانيا سيرا على الأقدام في رحلة استغرقت أسابيع، فقدت خلالها رفاقا عطشا ومرضا قبل أن تصل إلى نواذيبو.
هذه الحكايات تلخص مأساة مشتركة: موريتانيا بلد يهاجر أبناؤه بحثا عن الأمل، ويستقبل مهاجرين آخرين يحملون ذات الحلم، لتتجسد المفارقة بأوضح صورها.
القانون بين الالتزامات والضغوط
على الصعيد القانوني، تقف موريتانيا وسط معادلة معقدة:
• فهي طرف في اتفاقيات دولية تلزمها بحماية حقوق المهاجرين.
• لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط أوروبية متصاعدة لتشديد الرقابة ومنع تدفق المهاجرين نحو الشمال.
• داخليا، تفتقر البلاد إلى سياسة متكاملة لإدارة الملف، سواء لحماية المهاجرين العابرين أو لمتابعة قضايا مواطنيها في الخارج.
وقد أثارت منظمات حقوقية انتقادات لظروف مراكز الاحتجاز في نواذيبو ونواكشوط، معتبرة أنها لا تستوفي الشروط الإنسانية. في المقابل، تؤكد السلطات أن إمكانياتها محدودة، وأن المجتمع الدولي مطالب بدعمها إذا أراد منها الاستمرار في لعب هذا الدور.
التشريعات الأوروبية وتوسيع دائرة الرقابة
في السنوات الأخيرة، اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من القوانين والاتفاقيات الجديدة التي تستهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر المسار الموريتاني. فقد أقر البرلمان الأوروبي في 2021 ما عُرف ب”الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، الذي يركز على تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية وتسريع إجراءات الترحيل. كما وُقِّعت في 2023 اتفاقيات تعاون ثنائية بين بروكسل ونواكشوط، نصت على تمويل مشاريع لمراقبة السواحل وتجهيز مراكز احتجاز جديدة، إلى جانب تدريب قوات خفر السواحل الموريتانية. وفي هذا السياق، تُطالب بروكسل شركاءها في جنوب المتوسط بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية مقابل حزم دعم مالي، ما يثير جدلا واسعا حول ما إذا كانت هذه السياسات تراعي الالتزامات الإنسانية أم أنها مجرد مقاربة أمنية صارمة تحول الضفة الجنوبية إلى خط دفاع أول عن أوروبا. وقد أُسيء فهم بعض بنود هذه الترتيبات من طرف الرأي العام، حيث راجت شائعات بأن موريتانيا ستستقبل مهاجرين مُرحَّلين من أوروبا على غرار الاتفاقية البريطانية ـ الرواندية، وهو ما نفته الأطراف الرسمية مؤكدة أن الأمر يقتصر على التعاون في مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب.
– أثر اجتماعي وثقافي ممتد
للهجرة انعكاسات عميقة على البنية الاجتماعية. فقد ترك غياب الشباب فراغا في القرى، وغيّر ملامح الأسر الممتدة، وأعاد تشكيل أدوار النساء اللواتي أصبحن أكثر حضورا في تدبير شؤون البيت. أما في الخارج، فقد أسس الموريتانيون جمعيات ومراكز ثقافية، من ملتقيات أدبية في باريس إلى مدارس قرآنية في نيويورك، تعكس تمسكهم بالهوية ورغبتهم في توريثها للأجيال.
لكن هذا التمسك يصطدم أحيانا بتحديات الاندماج. فالأبناء الذين وُلدوا في المهجر يعيشون بين ثقافتين: ثقافة الأصل بما تحمله من تقاليد صارمة، وثقافة المجتمعات الجديدة بما تطرحه من قيم مغايرة، لتنشأ أزمات هوية بين جيلين. كما تظهر إشكالات لغوية وتعليمية بارزة: ففي فرنسا وإسبانيا يتعلم أبناء الموريتانيين بلغة البلد المضيف، ما يجعل العربية واللغات الوطنية عرضة للتراجع داخل الجيل الجديد. ولذا نشأت مبادرات أهلية لتعليم اللغة الأم وتحفيظ القرآن الكريم، في محاولة لموازنة الاندماج مع الحفاظ على الجذور.
– الهجرة كورقة سياسية
الهجرة في السياق الموريتاني لم تعد مجرد مسألة اجتماعية أو اقتصادية، بل غدت ورقة سياسية بامتياز. فالاتحاد الأوروبي يرى في نواكشوط شريكا أساسيا لحماية حدوده الجنوبية، فيما تستخدم الحكومة الموريتانية الملف كورقة تفاوض للحصول على دعم مالي وسياسي. وفي الداخل، يُوظَّف الخطاب حول الهجرة في الحملات السياسية والإعلامية، إما للتحذير من “التغيير الديموغرافي”، أو للتأكيد على دور الدولة كفاعل مسؤول في إدارة أحد أعقد ملفات العصر.
ويضاف إلى ذلك أن الإعلام الأوروبي يلعب دورا مضاعفا في تكوين صورة الهجرة عبر موريتانيا. فبينما تُقدَّم نواكشوط في بعض الصحف ك”حارس حدود” بالوكالة عن أوروبا، يرى آخرون أن السياسات الحالية تجعلها تتحمل أعباء لا طاقة لها بها. هذه الصورة المتباينة تغذي الجدل داخل موريتانيا نفسها، بين من يعتبر التعاون مع أوروبا فرصة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وبين من يخشى أن يتحول البلد إلى مجرد “سياج خارجي” للاتحاد الأوروبي.
– آفاق المستقبل – إلى أين
إن تجربة موريتانيا مع الهجرة تجسد ازدواجية فريدة: بلد عبور تستقر فيه آلاف الآمال الإفريقية، وبلد مُصدّر يغادره شبابه إلى أوروبا والخليج وأميركا. هذه المزدوجية تضع الدولة أمام امتحان عسير: كيف تُوازن بين مسؤولياتها الإنسانية والتزاماتها القانونية تجاه المهاجرين العابرين، وبين حاجتها لمعالجة الأسباب التي تدفع أبناءها إلى الرحيل؟
إنه سؤال مفتوح على المستقبل، مرهون بقدرة موريتانيا على صياغة سياسات شاملة وواقعية، تُراعي الأبعاد الإنسانية والحسابات الأمنية والاقتصادية. عندها فقط يمكن للبلاد أن تتحول من ممر ومصدّر ومقصد للهجرة إلى نموذج رائد في إدارة واحدة من أكثر ظواهر عصرنا تعقيدا؛ فالهجرة عبر موريتانيا ليست ظاهرة طارئة، بل امتداد لتحولات إقليمية ودولية أوسع. وإذا كانت أوروبا تنظر إليها من زاوية أمنية ضيقة، فإن جوهرها الحقيقي يظل إنسانيا قبل كل شيء. فالمهاجرون ليسوا مجرد موجات عابرة أو تهديدات ظرفية، بل بشر يبحثون عن الحياة بكرامة.
وتجد موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي الفريد، نفسها أمام فرصة لتقديم نموذج متوازن يوفق بين الالتزام بالمعايير القانونية الدولية وبين الحفاظ على القيم الإنسانية. نجاحها في ذلك لن يكون خدمة لمواطنيها فقط، بل إسهاما في ترسيخ مقاربة إنسانية للهجرة في منطقة ما زالت تموج بالأزمات.
إن مستقبل الهجرة في موريتانيا، كما في العالم، سيتحدد بمدى قدرتنا جميعا – دولا ومجتمعات – على النظر إلى المهاجر لا كرقم في إحصاء، بل كإنسان يستحق الحماية والكرامة.