قنينة “شنقيط”… نموذج لتهميش اللغة العربية حتى من الجهات المسؤولة عن حمايتها!

بقلم: سيدي محمد ولد اخليفه
لم تكن قنينة مياه “شنقيط” التي خلت من أي كتابة باللغة العربية مجرد زلّة تجارية عابرة، بل هي تجسيد صارخ لحالة أعمق من التهميش الممنهج للغة الرسمية، تنعكس في الإعلانات، واللافتات، والشعارات، حتى تلك الصادرة عن الهيئات التي يُفترض أن تكون حامية لهذا المبدأ الدستوري.
ففي الوقت الذي تنص فيه المادة السادسة من الدستور الموريتاني بوضوح على أن “اللغة العربية هي اللغة الرسمية”، نجد أن الشعارات الرسمية لبعض المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها شعار سلطة تنظيم الإشهار، مكتوبة فقط باللغة الفرنسية، في مفارقة مؤلمة: الجهة المخولة بضبط وتنظيم المجال الإشهاري لا تعكس في واجهتها احترامها للغة الدستور!
هذه المفارقة ليست معزولة، بل هي جزء من منظومة تغريب ناعم يتمدد في المساحات العامة؛ من لوحات المؤسسات، إلى لافتات المتاجر، إلى أغلفة المنتجات، وكلها تعج بالفرنسية، وتُقصي العربية كأنها لغة دخيلة لا لغة دولة وهوية.
مفارقة “شنقيط”
إن اللغة ليست تفصيلا شكليا،بل هي أداة سيادة، ووعاء للهوية،وسياج للوحدة الوطنية. والتهاون في فرص حضورها في الفضاءالعمومي هو تفريط تدريجي في استقلالنا الثقافي .
لذافإننا نطالب ب:
تصحيح فوري لمخالفات الشركات،بما فيها إعادة تصميم قنينة”شنقيط”وغيرها
مراجعة شعارات ولافتات الادارات،خاصة سلطة الاشهارلتكون بالعربية أولا.
وضع قانون يلز باستخدام العربية في الاعلانات واللوحات العامة
ليس من المقبول أن تبقي اللغة العربية غائبة بينما تفرض الفرنسية على كل قارعة طريق، في بلد عربي مسلم

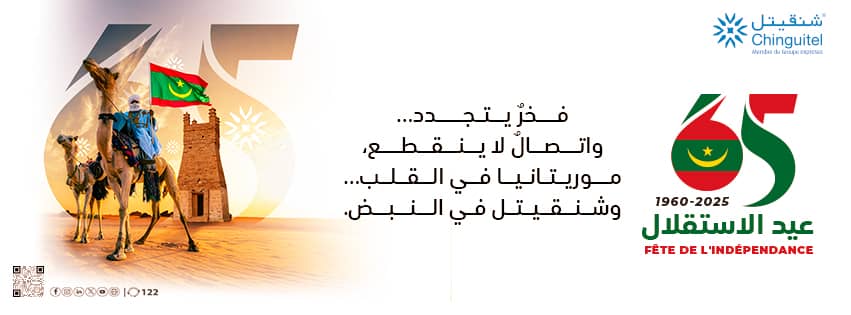









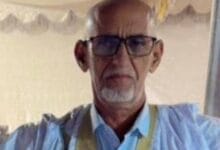
مقال للأستاذ سيدي محمد ولد إخليفه لامس جوهر معضلة ثقافية وسيادية عميقة، بأسلوب يجمع بين الوعي القانوني والغيرة الوطنية. فالقضية التي تناولها — قضية تغييب اللغة العربية من الفضاء العمومي — ليست مجرد خطأ في تصميم قنينة مياه، بل هي تجلٍّ رمزي لاختلال أكبر في أولويات الدولة ونخبتها الإدارية والاقتصادية.
لقد أحسن الكاتب حين نقل النقاش من مستوى الشكوى اللغوية إلى مستوى السيادة والهوية؛ فالعربية هنا ليست “لغة” فقط، بل عنوان لانتماء حضاري ومرجعية دستورية ينبغي أن تترجم في الممارسة اليومية قبل الشعارات.
وتميّز المقال في ثلاث نقاط أساسية:
1. الربط بين القانون والمشهد العام: حيث استند إلى المادة السادسة من الدستور، ليُظهر التناقض بين النص والممارسة.
2. التركيز على مسؤولية المؤسسات الرسمية: خاصة سلطة تنظيم الإشهار، التي يفترض أن تكون القدوة لا المخالفة.
3. الانتقال من النقد إلى الحل: عبر دعوة صريحة لإجراءات تصحيحية وتشريعية تُعيد الاعتبار للغة الرسمية.
إنّ ما يطرحه الكاتب ليس مطلباً لغوياً فحسب، بل نداء لإعادة التوازن في معركة الرموز داخل المجال العام، حيث تتحوّل اللغة إلى مقياس لهيبة الدولة وصدق انتمائها.
فإذا كانت الفرنسية هي لغة “اللوحات والإعلانات”، والعربية هي لغة “الدستور والقرآن”، فذلك يعني أن الهوية المعلَنة لا تتجسد في الواقع — وهذه هي المفارقة التي عرّاها المقال بذكاء وجرأة.
باختصار، هذا النص صرخة وعي في وجه تطبيع لغوي متدرّج، ودعوة لأن تكون اللغة العربية ممارسةً لا مجرد مادة في الدستور.